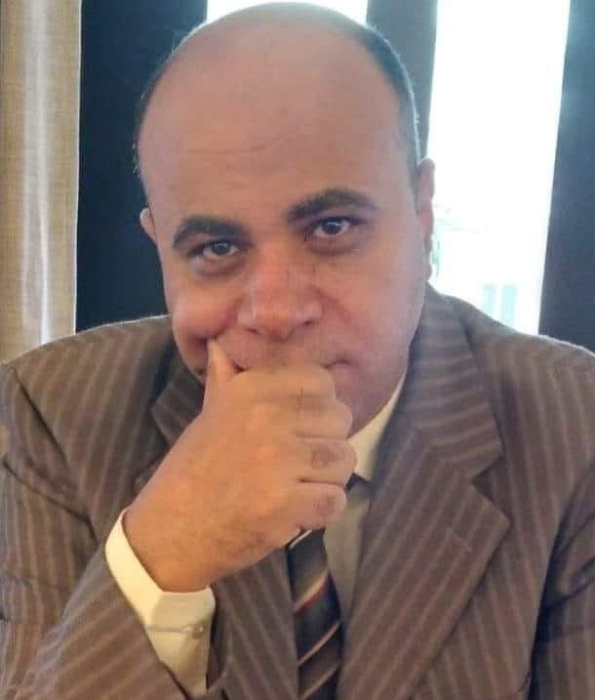عدالت عبدالله
منذ سنة
يُقال دوماً، وبعبارة شهيرة، إنَّ الدستور هو قانون القانون، أو أُم القوانين، ولا مراء في أنَّ كل قانون أو نص تشريعي يقتضي أن يكون مستنداً إلى قانون أعلى هو الدستور. وسمو القانون الأُم هذا على القوانين الخاضعة له، التي تشرعها المؤسسات التشريعية وتُلزَم بها السلطات التنفيذية في أي بلد، راجع أساساً إلى المرجعية الديمقراطية للدستور.
بعبارة أخرى، إن الدستور، بخلاف آلية صياغة القوانين العادية الصادرة عن مؤسسات ما، له أساس ديمقراطي ينبع من إرادة المجتمع ومكوناته المختلفة في اختيار قاعدة متينة وأساس حصين للقوانين التي تقترحها أو تشرعها مؤسسات الدولة لتنظيم البلاد والعباد.
علاوةً على ذلك، يُعتبر الدستور القانون الأعلى المُصادق عليه من قِبل الشعب، نظراً لإخضاعه لتقليد الاستفتاء الشعبي، الذي يمثل الآلية المعهودة في النظم الديمقراطية لتجسيد الإرادة المجتمعية التي يستقوي بها الدستور. إذن فالدستور، وبهذا المعنى، هو بمثابة العمود الفقري لكل دولة وكل عقد اجتماعي فاعل، وبالتالي فالحفاظ عليه والالتزام به، يساوي ما يمكن اعتباره واجباً وطنياً واستراتيجياً، غالباً ما تتوقف عليه وحدة البلاد أرضاً وشعباَ، فضلاً عن أنه يمثل مظهراً حضارياً أمام العالم.
وکما یقول لنا بعض الباحثین،،إن وجود أي جماعة سياسية منظمة يقتضي في الوقت ذاته وجود دستور لتلك الجماعة، هذا الدستور يحدد الأسس والقواعد التي تنظم حياتها. ومن البديهي ان نذكر ان وجود الدستور ارتبط بوجود المجتمع السياسي، بحيث أن أي مجتمع سياسي قائم فإنه يخضع لنظام سياسي معين، وبالتالي يتولى هذا النظام مهمة تحديد نظام الحكم داخل المجتمع، وتحديد العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. وهذا كله يمثل الأساس الناجع لبناء أي دولة سليمة ومستقرة، بل قوية بمفهومها الأوسع، أي بقوة حضور المشاركة السياسية الضمنية والمباشرة للمجتمع في تنظيم بُنية أمور الدولة وتجسيد تطلعات فئات الشعب ومصالح مكوناته.
والعراق ليس خارج هذه المعادلة التي نتحدث عنها بخصوص مفهوم الدستور وحقيقته، بل ربما هو البلد الذي بأمس الحاجة إلى الحفاظ على دستوره الدائم كمكسب تاريخي لا غنى عنه، خصوصاً أنه لم يشهد في تاريخه الجديد، أي منذ عام 1921 إلى يوم زوال النظام السابق (2003)، دستوراً دائماً، ولم يكن مجتمعاً متمتعاً بإرادة حرة لإقرار قانون ثابت لقوانين الدولة ودستور متأصل يستند إلى إرادة الشعب العراقي بكافة قومياته وأديانه ومذاهبه وأطيافه، ومن دون أي تمييز.
وانطلاقاً من هذه المسلمة، لا يمكننا في المدى المنظور تخيّل أن يكون العراق بلداً آمناً ومستقراً وموحداً من دون تطبيق عادل وشامل لمواد الدستور وبنوده، ولا يمكن أن يبقى صامداً أمام التحديات الداخلية والخارجية من دون حضور وسيادة مؤسسة حامية لهذا الدستور، مؤسسة تكون، قبل أي شيء، مُحايدة ومهنية، وبالتالي فاعلة ومتجاوبة مع النزاعات والخلافات التي لها طابعاً دستورياً وتحتاج الى تدخل حاسم منها.
صحيح ربما أنَّ كل دستور بحاجة إلى اجراء بعض التعديلات عليه على ضوء التطورات التي تفرضها الحياة السياسية والمقتضيات المجتمعية والاقتصادية، ولكن الصحيح أيضاً أنَّ أي تعديل مُقترح أو أي فكرة بخصوص مراجعة مواد الدستور لا بد أن تنطلق من هاجس وطني، هو تقوية وحدة المجتمع وتماسكه وتعاضده، وتنبع من تطلعٍ حضاري هو توفير الحريات والحقوق بصيغة أوسع لمكونات البلد وفئاته المختلفة، وليس التفكير والتدبير بعقلية مصادرة الحقوق والحريات تلك لأبناء الشعب، أو التقليل من شأن أي جزء منها أو الغاؤها. ومن الضروري أن تُلهِم هذه الشروط في التعاطي والممارسة حُماة الدستور أيضاً، إن كانوا أفراداً أو مؤسسات، وتحثهم على أن يكونوا في طليعة الحريصين على سلامة الوطن وأهله من كل فتنٍ ومكروه، لا سيما عبر مراقبة عادلة ومهنية للدستور، أو من خلال تأويل وتفسير موادها وبنودها المختلفة.
والأهم من كل ذلك هو عدم رضوخ المؤسسة المعنية بحماية الدستور، والتي تتمثل في الحالة العراقية في المحكمة الاتحادية العليا، لأي إملاءات سياسية تسيء إلى هيبتها أو تضرب دعائم مشروعيتها في ممارسة سلطاتها العليا في البلاد ودورها المفصلي في الحد من المنازعات السياسية والإدارية والقانونية، كما وعدم السماح أيضاً لأي جهة متنفذة في الدولة أو المجتمع السياسي، وخصوصاً الأحزاب السياسية، أن تشوه صورتها لأغراض سياسية أو بسبب قرارات المحكمة الصادرة بصدد الإشكاليات والخلافات التي تحتاج إلى تدخل دستوري من المحكمة الاتحادية كمؤسسة معنية قضائية عُليا لا غنى عنها.